علم الإمام عليه السلام بشهادته
سؤال قد يخطر في أذهان البعض وخلاصته: إن الإمام عليه السلام يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة، ومما يعلمه أيضاً زمان قتله ومكانه ووسيلة القتل، وقد صرحوا بذلك كثيراً[1]، بل تواتر النقل في أن أمير المؤمنين عليه السلام كان قد صرح بزمان قتله، وعيّن قاتله، وأبى أن يقتص منه قبل الجناية[2]، وكان الحسين عليه السلام يعلم بذلك، وحدد أرض شهادته، واصطفى أصحابه، وبين كيفية شهادته والحوادث التي تجري على أهل بيته، وأكد لمن طلب منه أن لا يذهب إلى كربلاء، فقال: «شاء الله أن يراني قتيلاً» ولمن طلب منه أن يترك عياله في المدينة قال: «شاء الله أن يراهن سبايا»[3].
وكذلك أمه الصديقة قامت واغتسلت وأوصت وأخذت تتلو القرآن حتى قضت شهيدة مظلومة[4].
وقال الإمام الرضا عليه السلام لابن الجهم في قاتله المأمون العباسي: «فإنه سيقتلني بالسم وهو ظالم لي، أعرف ذلك بعهد معهود إليّ من آبائي عن رسول الله1، فاكتم هذا عليّ ما دمت حياً»[5] وهكذا تحدث سائر الأئمة عليهم السلام، بل قال الصادق صلوات الله عليه: «أي إمام لا يعلم ما يصيبه وإلى ما يصير فليس ذلك بحجة لله على خلقه»[6].
وباختصار: أن الإمام عليه السلام يعلم بزمان قتله ومكانه وكيفيته كما يعلم بقاتله فكيف مضى لسبيله ولم يدفع عن نفسه ذلك وألا يعد هذا من إلقاء النفس في التهلكة الذي نهى عنه الباري عز وجل بقوله: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾[7] ؟ ولا يخفى أن السؤال المذكور يستبطن إنكارين هما إنكار علم الإمام عليه السلام بالمقدرات الإلهية تخلصاً من محذور الإقدام على التهلكة، وإنكار العصمة تخلصاً من محذور عدم العلم.
وقد أجيب عن هذا التساؤل بأجوبة عديدة لا يخلو العديد منها من إشكال[8]؛ لاستنادها إلى روايات وردت في مقام التقية المداراتية أو الخوفية كالتي نصت على أن الله سبحانه يُنسي الإمام الأمر لينفذ فيه حكمه[9]، أو ينقطع عنه المحدث الذي يخبره بالحدث[10]، أو أنه يفعل ذلك من باب الاضطرار ونحوها[11]. أو لمخالفتها لحكم العقل والنقل كالقول بنفي الحجية عن علومهم عليهم السلام الحاصلة من غير الطرق المتعارفة؛ لأن الدنيا دار الاختبار والعمل بالظاهر لا الواقع، أو بعدم التفاتهم عليهم السلام إلى العلم والمعلوم بسبب استغراقهم في محبة الخالق وقربهم منه كما يكشف عنه إخراج النصل عن رجل أمير المؤمنين عليه السلام في الصلاة مع عدم التفاته وانقطاعه إلى ربه إذ مع فرض عدم الالتفات لا يصدق الالقاء في التهلكة، أو بعدم علمهم بانطباق المجمل على المفصل، بدعوى أنهم عليهم السلام أخبروا بما يقع عليهم ويكون سبباً لقتلهم ولكن لا يعلمون الوقوع تفصيلاً لتعدد احتمالات الوقوع وانطباقه على موارد عديدة، والعقل يقضي بلزوم الاجتناب في الشبهة المحصورة لا غير المحصورة إلى غير ذلك من أجوبة لا تتوافق مع القواعد والأصول الصحيحة[12].
لأن الجواب الأول مخصص للقاعدة العقلية القاضية بحجية العلم مطلقاً ومفكك بين الذات وذاتياتها على أن نفي الحجية لا ينفي عنه عنوان الالقاء في التهلكة.
والجواب الثاني متناقض؛ إذ لا يعقل اجتماع العلم مع عدم الالتفات على أن عدم الالتفات ينافي العصمة، ومثله يقال في الجواب الثالث فضلاً عن منافاة الجميع لصريح الأدلة النقلية التي نصت على شمول علمهم واحاطته وفعليته فيما كان ويكون وما هو كائن.
ولعل الإجابة الأوفق بالقواعد والأصول العقلية والنقلية تتلخص في جواب نقضي بمثل المجاهدين في سبيل الله الذين أمروا بالجهاد مع علم الكثير منهم بالشهادة، وجواب حلي هو الخروج الموضوعي عن التهلكة، ويمكن بيانه من وجوه:
الوجه الأول: فقهي، فإن التهلكة موضوعاً تتحقق في صورة الإقدام على ضرر القتل من دون حكمة و نفع أكبر، وهذا غير متحقق هنا؛ لأن الإمام عليه السلام يقدم على الشهادة ومصلحة الشهادة وكرامة الشهيد أكبر من ضرر القتل، وعلى هذا الأساس يقدم جميع العقلاء عليها دفاعاً عن العرض والوطن والدين، وتعد الشهادة من أقدس قيم البشر، والشهيد من أنبل أبنائهم عند جميع أهل الأديان والمذاهب والملل، فما بالك بمن يضحي بنفسه لأجل دين الله وأحكامه.
فإقدام الإمام عليه السلام للتضحية في سبيل الله خارج موضوعاً عن آية التهلكة؛ لأنه شهادة وليس بتهلكة، وهذا ما تؤكده الروايات العديدة التي تنص على أنّ الله سبحانه خيّرهم بين الموت وبين لقاء الله سبحانه، فاختاروا لقاء الله تبارك وتعالى حباً وشوقاً وتحصيلاً للمثوبات ومزيد الدرجات.
فعن أبي جعفر عليه السلام قال: «أنزل الله تعالى النصر على الحسين عليه السلام حتى كان ما بين السماء والأرض، ثم خيّر بين النصر أو لقاء الله فاختار لقاء الله تعالى»[13].
ويمكن إخراج الإقدام على القتل من التهلكة موضوعاً بوجه آخر ذكره العلامة المجلسي رحمه الله.
وخلاصته: أن الإمام عليه السلام يعلم بأنه سوف يقتل بما هو أشد وأشنع مما جرى عليه لو لم يقدم على القتل، فيختار الأخف؛ بداهة أن مثل المأمون العباسي ونحوه الذي يقتل الرضا عليه السلام بالسم النقيع لا يمنعه مانع من قتله بما هو أشد من ذلك، وحيث إن الإمام عليه السلام يعلم بذلك فيقدم على الأخف لكي لا يقع الأشد، وعليه يكون الإقدام على القتل من باب دفع الضرر الكبير بالأقل منه[14].
أو لعل الإمام عليه السلام يعلم بأنه إذا لم يقدم هو على القتل ستبتلى شيعته بالظلم الفظيع من قبل السلطة، وهذا أمر معهود في سياسات الظلمة حينما يفتكون بمخالفيهم، فإنهم إذا نالوا من الزعيم يخف ضغطهم على الأتباع، ولعل هذا ما يشير إليه قول الإمام الكاظم عليه السلام بأنه وقى شيعته بنفسه بسبب ما يمكن أن ينزل عليهم من البلاء، ولا يخفى ما في هذا المعنى من تضحية ورأفة كبيرتين[15]، وهذه قاعدة عامة تجري لدى التزاحم بين المنافع والأضرار في كل الأمور وبها يندفع الإشكال.
الوجه الثاني: قيادي، فإن الله سبحانه نصبهم عليهم السلام أئمة للناس وحججاً عليهم ليكونوا قدوة لهم في كل شيء، لاسيما في مواطن الضراء والصبر والتضحية في سبيله؛ وذلك لأجل إتمام سنّة الاختبار والامتحان التي جبل الله سبحانه عليها الدنيا وما فيها لتربية الناس إعداداً لهم للآخرة.
ولازم هذه الحكمة أن يتعامل النبي والإمام عليهم السلام مع ما ينزل عليهما من آلام ومصائب بحسب ظاهر الحال كما يتعامل سائر الناس، لا بحسب الواقع؛ ليكونوا قدوة وأسوة[16]، وإلاّ بطلت سنّة الامتحان، ولم يبق وجه للاقتداء بهم؛ وأمكن أن يقال بأن علياً عليه السلام - مثلاً- أقدم في الحروب وبات على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وبرز لعمرو ابن عبد ود ونحوه لأنه يعلم بعدم موته وهكذا سائر الأئمة عليهم السلام.
فهم عليهم السلام مأمورون بالعمل بحسب الظواهر بما في ذلك من اضرار ومتاعب ويشاركون الناس في الأحكام والوظائف ليكونوا قدوة لهم بما أنهم أئمةً وحججً.
الوجه الثالث: معرفي، فإن الإمام عليه السلام يعلم بالمقادير الإلهية في اللوح المحفوظ ، ويعلم أن مما قدره الله سبحانه لمصلحة دينه وأحكامه أو لمصلحة خلقه أن يكون الإمام عليه السلام مقتولاً بالسيف أو بالسم بالتفاصيل التي قدرتها المشيئة الإلهية، فلذا لا يملك إلاّ أن يكون مستجيباً للمشيئة، ومحققاً لما أراده الله سبحانه منه؛ إذ لا يكون الإمام إماماً إلاّ أن يكون عبداً لله، مستجيباً لإرادته، ومسلماً لأمره في كل شيء، فلذا يقدم على القتل لأن الله يحب أن يراه مقتولاً، ويقدم على شرب السم لأن الله سبحانه يحب أن يراه مسموماً.
وفي هذا ينال الإمام عليه السلام علو الدرجات ومزيد القرب الإلهي، كما يبدي غاية الخضوع والطاعة لرب العالمين، ويصبح القتل عنده عبادة وامتثالاً لا تهلكة، وإلى هذا يشير قول سيد الشهداء: «خير لي مصرع أنا لاقيه»[17] وقوله: «شاء الله أن يراني مقتولاً»[18] و: «شاء الله أن يراهن سبايا»[19] فإن الخيار والمشيئة هنا تشريعيان لا تكوينيان، بمعنى أنه عليه السلام علم بأن الله سبحانه اختار له القتل بالسيف في سبيله، وأحب أن يراه قتيلاً وعياله سبايا، وهو لم يألوا جهداً أن يحقق هذا الحب، ويمتثل لأمر الله، وبه يظهر بعض وجوه العناية الإلهية بسيد الشهداء عليه السلام حتى عوض بشهادته بمزيد من الألطاف والفيوضات التي لم يعطها حتى للأنبياء، حيث جعل قبره موضعاً لمختلف الملائكة، وتربته شفاء من الأمراض، وقبته موضع استجابة الدعاء، وجعل بيده مفاتيح العلم والرحمة والمحبة في قلوب المؤمنين؛ لأنه أعطى لله كل ما يملك حباً وكرامة، فأعطاه الله الكثير مما يملك حباً وكرامة، كما تنص عليه الروايات، ويشهد به الواقع الخارجي.
كما يظهر أن تضحيات الأئمة عليهم السلام وإقدامهم على القتل ليس من باب الجبر أو الاضطرار، بل هو من باب الاختيار لأفضل العطاء وتقديمه في سبيل الله سبحانه، ولا شك في أن أفضل ما يبذله العبد في سبيل ربه هو روحه ودمه.
ولعل مما يشهد له ما ورد عن مولانا الرضا عليه السلام في بيان سبب إقدام أمير المؤمنين عليه السلام على الصلاة في المسجد مع علمه بما يجري فيها. قال: « ذلك كان ولكنه خيّر في تلك الليلة لتمضي مقادير الله عز وجل»[20].
لاسيما وهم المشتاقون إلى لقاء الله سبحانه، والمتفانون في حبه، ويجهدون لأجل وصاله، وقد طلقوا الدنيا وعادوها لما فيها من بعد عن محبوبهم، وإشغال عن عبادته، وأرادوا الموت في سبيله للوصول إليه، ولذا قال أمير المؤمنين عليه السلام: «لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل بثدي أمه»[21] لما فيه من سمو وراحة إليه، وقال عليه السلام: «فلولا الآجال التي كتب الله لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين، شوقاً إلى لقاء الله والثواب»[22].
ففراق الله سبحانه بالنسبة إليهم عذاب يلوعهم، ويكوي قلوبهم، ولذا كان يقول في مناجاته: «إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك، فكيف أصبر على فراقك؟»[23] وبهذا يظهر أن راحتهم وسرورهم في الشهادة في سبيل الله؛ لأنهم يحققون بها الإرادة الإلهية، وينجزون المقدرات التي أحب الله أن تجري في الوجود، وفي عين الحال توصلهم إلى ربهم، وتخلصهم من سجن الدنيا وظلماتها.
كما وروي عن الإمام زين العابدين عليه السلام: «والله ... لا يشغلني شيء عن شكره وذكره في ليل ولا نهار ولا سر ولا علانية، ولولا أن لأهلي عليّ حقاً ولسائر الناس من خاصهم وعامهم عليّ حقوقاً لا يسعني إلاّ القيام بها حسب الوسع والطاقة حتى أؤديها إليهم لرميت بطرفي إلى السماء وبقلبي إلى الله ثم لم أردهما حتى يقضي الله على نفسي وهو خير الحاكمين»[24].
وبهذا يظهر أن معيشتهم عليهم السلام في الدنيا ومعاشرتهم للناس هي عبارة عن إيفاء للحقوق، حق الله في العبادة، والعمل لرضاه وكسب ثوابه، وحق الناس في تربيتهم وتعليمهم وهدايتهم إلى الله سبحانه حسبما أراد الله سبحانه، وحق الأهل لمثل ذلك، ولولا هذه الحقوق لانقطعوا إلى خالقهم ولم يلتفتوا إلى شيء من الدنيا طرفة عين أبداً، وهذه هي العبودية الحقيقية لله، فالعبودية المخلصة للعبد هي أن يتفانى في سبيل ربه حباً وشوقاً وامتثالاً.
وهذا ما يؤكده قول الصادق عليه السلام: «العارف شخصه مع الخلق وقلبه مع الله، لو سها قلبه عن الله طرفة عين لمات شوقاً إليه.... فلا مؤنس له سوى الله، ولا نطق ولا إشارة ولا نفس إلاّ بالله، ولله ومن الله ومع الله، فهو في رياض قدسه متردد، ومن لطائف فضله إليه متزود»[25].
ويتحصل مما تقدم: عدم التنافي بين علم الإمام عليه السلام واحاطته بعوالم الغيب التي أعطاها الله له وبين إقدامه على الشهادة في سبيله؛ لأن بإقدامه على الشهادة يمتثل أمر الله سبحانه في الجهاد والتضحية في سبيله، وينقاد إلى المقدرات الإلهية التي قررها الباري عز وجل لخلقه، وبهذا الانقياد يكون الإمام عليه السلام في غاية العبودية والتسليم والانقطاع لربه عز وجل، فإقدامه على التضحية خارج موضوعاً عن التهلكة المنهي عنها، وداخل في موضوع الجهاد والطاعة للخالق تبارك وتعالى، وهو مقتضى العلم والعصمة لا نفيهما.
مقتبس من كتاب الحقائق والدقائق في المعارف الإلهية / الجزء الخامس / الإمامة / ص 406 - ص 414
تأليف سماحة الشيخ فاضل الصفار
[1] - انظر بصائر الدرجات: ص500- 501، باب في الأئمة3 أنهم يعرفون متى يموتون.
[2] - الخرائج والجرائح: ج1، ص201، ح41.
[3] - انظر الهداية الكبرى: ص203- 204؛ مشارق أنوار اليقين: ص88.
[4] - انظر فضائل الخمسة من الصحاح الستة: ج3، ص198؛ مقتل الخوارزمي: ج1، ص85؛ فضائل الصحابة: ج2، ص629؛ كشف الغمة: ج2، ص42.
[5] - بحار الأنوار: ج25، ص136، ح6؛ جامع كرامات الأولياء: ج2، ص256.
[6] - الكافي: ج1، ص258، ح1؛ بصائر الدرجات: ص504، ح13.
[7] - سورة البقرة: الآية 195.
[8] - انظر آل محمد3 بين قوسي النزول والصعود: ص163 وما بعدها.
[9] - انظر بصائر الدرجات: ص381، ح3؛ بحار الأنوار: ج48، ص235- 236، ح42
[10] - رجال الكشي: ص371؛ بحار الأنوار: ج48، ص242، ح50.
[11] - انظر المسائل العكبرية: المسألة العشرون، ص70.
[12] - انظر الؤلؤة الغالية: ص28- 44، لؤلؤة (4).
[13] - الكافي: ج1، ص260، ح8؛ بحار الأنوار: ج45، ص12.
[14] - انظر بحار الأنوار: ج 48، ص 236، بيان.
[15] - انظر الكافي: ج1، ص260، ح5.
[16] - انظر بحار الأنوار: ج 48، ص236؛ الفقه (البيع): ج4، ص271.
[17] - مثير الأحزان: ص29؛ لواعج الاشجان: ص70؛ معالم المدرستين: ج3، ص304.
[18] - بحار الأنوار: ج44، ص331؛ لواعج الاشجان: ص31.
[19] - مختصر بصائر الدرجات: ص132؛ المحتضر: ص41؛ بحار الأنوار: ج44، ص364؛ لواعج الاشجان: ص73؛ اللهوف في قتلى الطفوف: ص40.
[20] - الكافي: ج1، ص259، ح4.
[21] - تذكرة الخواص: ص121؛ بحار الأنوار: ج 28، ص 234، ح20؛ المحاسن والمساوئ: ص483؛ نضد القواعد الفقهية: ص72؛ بحار الأنوار: ج71، ص57، ح16.
[22] - بحار الأنوار: ج 65، ص193، ح48؛ كنز الفوائد: ص32؛ وانظر كتاب سليم بن قيس: ص372؛ تحف العقول: ص159.
[23] - إقبال الأعمال: ج3، ص335.
[24] - مستدرك الوسائل: ج1، الباب 18 من أبواب مقدمة العبادات، ص126، ح11؛ آل محمد بين قوسي النزول والصعود: ج2، ص170.
[25] - بحار الأنوار: ج 3، ص14، ح35؛ مصباح الشريعة: ص191.
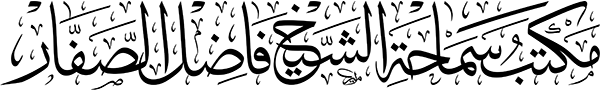

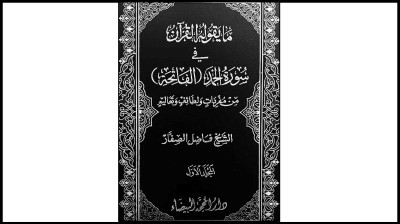
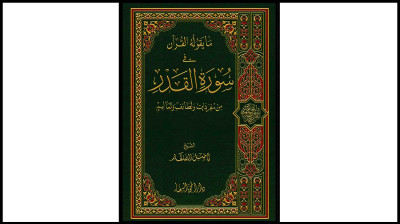
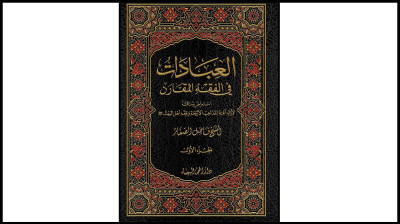
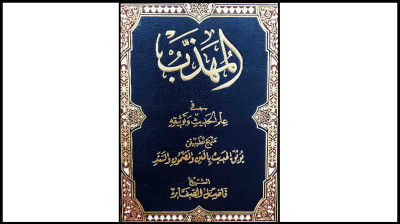
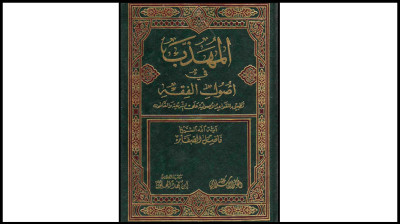
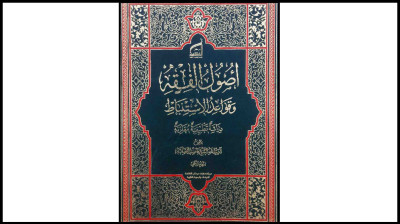
اضافةتعليق
التعليقات